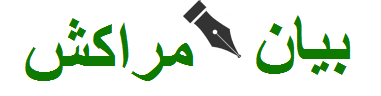بحث في المقبرة*:
“””””””””””””””””””””””””””
في ركني المنزوي بالمقهى، حيث أخربش مرارة أيامي على بياض الورق، كانت تأتيني التماعة الرغبة الملحاحة في عينيه اللتين ما تفتآن مسمرتين على وجهي. أحببت انكباب نظراته على حضوري المعطل الغارق في انتظار ما لا يأتي، وغمرني حس بالمعنى في عالم يتراكض قاحلا بلا مبالاة.
باغتني بانتصابه أمام طاولتي، يسألني، بشفتين متبسمتين، ورقة وقلما. ترددت قليلا، وقد فطنت إلى قصده الخفي، ثم أجبته إلى طلبه وكأني أتواطأ معه. حياتي كانت تمتد، في وجهها المشرق، ما بين قلم الرصاص والورقة البيضاء، فكأني أقرضته حياتي.
من خلف الحاجز الحديدي للقنطرة، تطلعت إلى جانب من الوادي. بدت لي المياه الموحلة وفيرة لا تفتر عن الحركة، تلتمع بضوء الشمس الخافت، وتهدر باندفاع جارفة قاذورات وبقايا أشياء. رنوت شاردة إلى مشهد المياه العكرة الهائجة، وفكرت في مائي الداخلي: تفجر صافيا متألقا، إثر غزوات نظرات مُغوية وكلمات تتقن العزف على القلب ولمسات دافئة. لكنه ما لبث أن امتزج بالوحل الآسن.
لما رفعت كفيّ عن قضيب الحاجز، كانتا نديتين باردتين، وقد علق بهما صدأ الحديد. أدخلتهما في جيبيْ معطفي الجلدي، وحثت خطاي منحدرة باتجاه البوابة الخشبية العتيقة، فيما كانت تلوح من وراء السور الطيني نباتات شوكية وقبور خفيضة.
على الأرض المتربة المبلولة سرت. تباطأت خطواتي إذ بدأت أدنو من البوابة. في جسدي دبت رعشة خفيفة، تشبه تلك الرعشة التي تتلبسني حين كنت أترقب مجيئه إلى موعد، أو حين كنت أغذ السير نحو شقته. غير أني كنت، هذه المرة، عارية من الشوق واللهفة والحرقة المحببة. توقفت على بعد خطوات من البوابة تصطخب بداخلي ذكرى الوقائع التي غارت عميقا في أحشائي، ورحت أحدق في جسد الخشب المسكون بظلال من عبروا إلى الشط الآخر: كان خشنا متشققا، ترابي اللون، مائلا إلى اليسار قليلا، ب”زكروم” (رتاج) من حديد ينطق بالقوة والصلابة. استبدت بي فكرة الهشاشة التي تسكن الأشياء، وومضت في خيالي لوحة داكنة لجسد من خشب يوارى التراب.
نبه سمعي وقع أقدام ثقيل على التراب المبلول، تلفت فرأيت على يميني امرأتين قادمتين في اتجاهي، ومن خلفهما تبدو الطريق المظللة بسعف النخيل. مرتا بقربي فحيتاني، وقصدتا البوابة الخشبية. كانتا تشبهان أمي، بالجلباب الضافي والنقاب الأسود الشفاف، بالمشي المتأني والتحية المهذبة المطمئنة. وما أن توارت عن ناظري قامتاهما القصيرتان في اكتناز متفاوت، حتى اشتعلت في روحي الرغبة التي قادتني إلى المقبرة، وزايلني التوجس والرعشة، فاقتفيت أثرهما وقد أحسست بأن الجو آخذ في الابتراد.
كنت قد تسللت، صبيحة هذا اليوم، إلى شقته تدفعني حاجة غامضة لا تقاوم. فتحت الباب بنسخة المفتاح التي كان قد اختصني بها، عربون ثقة وحميمية. رأيت على المائدة البلاستيكية بقايا غداء أو عشاء: قليل من السمك المصبر والزيتون المفلفل، قطعة خبز يابس، وزجاجة “كوكا” فارغة ترسبت في قعرها ذبابة. الأواني متكدسة في حوض المغسلة، متعفنة، وتحت المغسلة كيسان بلاستيكيان للقمامة، تفوح منهما رائحة كريهة، ويطوف حولهما سرب من الناموس الأشقر. كانت قارورة معطر الجو أمامي فوق سطح الثلاجة، لكني لم أستطع أن أمد إليها يدي: عبثي أن أحاول تبديد هذه الرائحة المزكمة! كم أحتاج من رشة كي أخلص أعماقي من رائحة خيبة فادحة؟
تهالكت على الكنبة الموضوعة في جانب من الغرفة، وتنهدت عميقا. الملاءة مكومة فوق سريره (سريرنا؟)، وثمة كومة من الجرائد مبعثرة على الحصيرة البلاستيكية. ألم أكن قاهرة هذه الفوضى؟ لو كانت الأشياء قادرة على النطق، ألم تكن لتشهد بأني طالما وجهت إليه عتابا رقيقا على إهماله ولامبالاته، ساعية، بشغف نملة، إلى غرس النظام والنقاوة والجمال في الشقة؟ ألم تكن لتقر بأنه كان يستسلم، راضيا ممتنا، للترتيبات التي كنت أعالج بها روح المكان. ونظراته؟ كلماته؟ لمساته؟ هل ما تزال بعد عالقة بالأشياء، ملتهبة مشبوبة واعدة؟ أحيانا كان ينسى فيسقط في التناقض. أحيانا كان يعثر على أعذار معقولة ليتخلف عن أحد مواعيدنا. أحيانا كان يقذف بمستقبلنا معا إلى البعيد البعيد، سالكا درب التسويف. لكني كنت أغفر، بل كنت أنحي عنه كل شبهة. يكفيني عندئذ أن يكون قادرا على تذويب شكوكي، أن يربت على أحلامي بيده الرؤوفة. كان يقول لي: «إني أتنفسك». والدليل لوحاتي التي تزين جدران غرفته: كانت تحرسه في غيابي.
حاصرتني صور الذكرى، حاصرني البكاء. هببت واقفة، أريد الانفلات من ماض يأخذ شكل شقة. وأنا أمضي متثاقلة نحو الباب وعيت، كأنما لأول مرة، بأنه لم يعد.. بأنه راقد، في هاته اللحظة، في قبر ضيق محكم الإغلاق.
انداح أمام عيني مشهد القبور مغلفا بسكون أبيض تمازجه الرهبة، وفوقه ترامت السماء شاحبة الزرقة، تتخللها غيوم سوداء، وغيوم يخترقها ضوء الشمس الواهنة. هسيس السكون حرك في نفسي شعورا مضاعفا بالوحشة التي لم تكف عن نهش طمأنينتي، منذ انفتحت الهاوية تحت قدمي. ابتلعت ريقي وقد انساب من لساني تشبيه معزّ: «موحشة مثل مقبرة!».
بدأت طوافي بين القبور أتفحص الشواهد واحدة تلو الأخرى. مسحت بنظري أسماء أموات شتى، وكان قلبي يقفز من صدري كلما صادفت اسما شبيها باسمه. الكنية وحدها صارت مطمح بحثي وسط متاهة من قبور.
إعياء جلست على الأرض، مستندة بيدي إلى قبر أصغر حجما من القبور الأخرى. ودَوّمَني إحساس بالعبث: ماذا سأصنع بقبره؟ ماذا يعيد علي المثول بين يدي ميت لا حول له ولا قوة؟ أجئت للبكاء أم للعزاء أم للتشفي؟ أتراه يبصرني من موته، فتأكله ديدان الحسرة والندم؟ ربما جئت أطلب ما يعيد إلي ثقة روحي التي سممها بالطيش.. ربما جئت لأصفي حسابا مؤجلا.. أو ربما – من يدري؟ – جاء بي حنين إليه ما يزال ثاويا في أعماقي…
الذكرى الفاجعة هاجت بنفسي، وانذرفت من عيني دمعة ساخنة. غمغمت متهكمة: «سأرسمه ميتا!». وتطلعت توا إلى السماء فوقي، وبودي أن أرى بحرا مصطخبا بدوامات متموجة يلتهب قلبها بالنار: السماء التي رسمها «فان غوخ» بأصابع جنونه. ليلة غوخ المرصعة بالنجوم، كانت ترعبني، وتلقي بي في هول التيه. أما السماء المرتفعة فوقي، فقد كانت رصاصية اللون، مضمخة بهواء رطب بارد، كأنها تنذر بالمطر، وثمة طائر وحيد يحلق باتجاه الغرب. عبر ذاكرتي، في وضوح غريب، وجه وسيم أسمر، بجسد رياضي قصير، وأخذ الوجه يتموج مُدَوِّماً حتى انطفأ.– ما بك يا ابنتي؟
أيقظني السؤال المباغت من شرودي، فوقفت خجلة من نفسي، ونظرت إلى المرأتين اللتين تشبهان أمي، وأجبت:– فقط أبحث عن قبر.. أحد أقربائي.
التمع الاستغراب في نظرات المرأتين، واقترحتا علي أن أسترشد بحارس المقبرة. شكرتهما، ولم ألبث أن سلكت طريقا لا يفضي إلى غرفة الحارس. كنت أدرك أني ضاعفت استغرابهما، إلا أني كنت مصرة على مواصلة بحثي، كما لو أن ثمة تحديا مشهرا في وجهي.
أرغب أن أعثر عليه، هذه المرة، متلبسا بحقيقته: كونه مجرد قبر. لقد أجاد الانحجاب، في المرة الأولى، ولم أكشف كذبه إلا صدفة. حادثة سير أطاحت بالأوهام التي كانت تشدني إليه: لمحته في غرفة الإنعاش، ضائعا في عتمة الغيبوبة. ولمحتها من بعيد، راقدة على سرير في إحدى قاعات المستشفى، بيدها كسر وعلى وجهها كدمات. قيل لي: تلك المرأة صاحبته!
يومئذ زلزلت الأرض من تحت قدمي، تداخلت الأشياء في بعضها البعض، وانهار شيء كان ينمو بين ضلوعي، شيء عفوي ونقي ودافئ وعذب وصاخب…
كتمت الإحساس الفادح الذي راح يرج روحي، وذهبت ذات ظهيرة إلى المستشفى لأعود غريمتي المزعومة. عولت على باقة ورد لأفتح نافذة إلى قلبها، وقدمت نفسي على أني إحدى قريباته. لم تشك لحظة في هويتي، بل بدت ممتنة لي على الزيارة التي لم تتوقعها. ولأني كنت أود أن أكشف عن صحة الخبر الذي ما انفك يخنق أنفاسي، فقد عرفت كيف أعزف على الأوتار التي تفضح المكتوم. أخذت غريمتي تسرد علي، بالتذاذ مشبع بالتفجع، الخطوط العريضة لعلاقتها به. لم تطاوعني نفسي للتصديق بحكاية لم تبد لي مختلفة في شيء عن حكايتي معه، كنت أرغب أن أصرخ في وجهها، أن ألطمها بيدي معا: «كذب ما تدعينه.. كذب كذب..». لكني لم أملك إلا أن أهبها، مرغمة، ثقتي: كان الصدق يتفجر شفافا من تعابير وجهها، نبرة صوتها، ونظرات عينيها. قالت إن علاقتهما قد انتسجت منذ ما يقارب ثلاثة أعوام (أي قبل عام من علاقتي به!)، وإنه يحبها حد الجنون ويحلم أن يضمهما عش الزوجية، وإنه كان ينتوي أن يخطب يدها قريبا لولا هذه الحادثة المشؤومة، وإنه.. وإنه..
كانت ترسم أمامي تقاسيم خيانة لم أكن وحدي ضحيتها، كنا معا ألعوبة في يد كلمات تربت على القلب ووعود تداعب الرغبة، لكن كان ثمة فرق بيننا: أنا رأيت صورتي في مرآة الكشف، بينما هي ما تزال سادرة في سحر الوهم. تبدد في لحظة كل الحقد الذي جئت محملة به تجاهها، تبدت لي صورتي مجسدة، بخطوط ناتئة، على لوحة نفسها، وأشفقت عليها إذ كانت أفدح مني انخداعا: لقد سقطت قبلي. وكدت أنهار باكية على صدرها، بل إني قد فعلت، دون أن أجرؤ على مكاشفتها بالحقيقة، تركتها تعتقد أني أشاطرها فجيعتها في الحبيب القريب.
نحيب يخفت ويتعالى، حملت الريح صوته إلى سمعي. تلفت نحو الجهة التي يأتي منها الصوت، فرأيت شخصا يقف أمام شاهدة قبر يحاذي حافة هاوية، لعلها “خطّارة”. تقدمت خطوتين باتجاهه، فتجمدت في مكاني: كانت قامته، بكنزة صوف “الجكار” وسروال “الدجين”، قصيرة مكتنزة، وكانت صلعة رأسه تبدو من الخلف لامعة يحفها شعر أسود ناعم. فعلا كان ينتحب، لكني لم أر وجهه. كان يخفيه بين يديه ويهتز من الانتحاب. من غير شك، تلك قامته المشعة بالقوة والعنفوان، وذلك رأسه المسكون بالأفكار والكلمات والأشياء الأخرى، تلك ثيابه الأنيقة التي غسلتها مرارا بيدي هاتين، وذلك لونه الأسمر الذي هاجر إلى لوحاتي. أرجفت الرعشة جسدي، وخفف نحيبه لهيب جرحي. كنت أشتهي أن أدنو منه، فأرفع يديه عن وجهه، وأحملق فيه ملء أحداقي، من غير كلمة واحدة، فقط بتعبير هادئ يشي باحتجاج مكتوم، بتشف شجي. غير أني لم أفعل. كان ما رأيته قد تبدد مثل طيف…
وأنا أشق طريقي نحو بوابة المقبرة، تساقط رذاذ على وجهي، وأحسست بالبرد ينفذ إلى ضلوعي، فأغلقت معطفي الجلدي ورفعت ياقته إلى أعلى حماية لرقبتي. كبر الرذاذ، ونزل فوق القبور، فبدت مغسولة ناصعة، ومن الأرض تصاعدت رائحة التراب. وفيما أنا أسرّع خطوي، رأيت البوابة مشرعة، يدلف منها موكب في مقدمته نعش مرفوع على الأكتاف. كانت الجنازة تتقدم صامتة، من غير وقار، فقد أربك المطر الخطى وجعلها حذرة عجولة. تنحيت عن الطريق جانبا كي يمر موكب الجنازة، وهربت بعيني إلى القبور المجاورة.
كانت قراءة أسماء الموتى قد أرهقتني ، غير أني استسلمت لرغبة الدنو من قبر باذخ، يلتمع، عن بعد، زليجه الأزرق. استفزني بمظهره المتعالي: الشاهدة الرخامية الموشاة بالخط المغربي، الحوض الذي نمت فيه الخبّيزة بكثافة، و… كأن الراقد فيه لم يكن متساويا مع الموتى الآخرين في حقيقة الموت! فكرة المظهر المضلل حركت في نفسي صورة ذلك الذي أحببته بكل جنوني، فتمتمت: «مثل هذا القبر!».
واقتحم عينيّ اسمه على غير توقع، عندما كنت منخرطة في تفلسف موجع. كان قبره يقع على مسافة خطوات من القبر الباذخ. لم أشعر، في غمرة اصطخاب أحاسيسي، إلا وعيناي تغرورقان بالدمع. أخذت أحدق في القبر وقد بللني المطر الذي راح يسقط بسعار، وهجمت علي الذكرى البعيدة:
في ركني المنزوي بالمقهى، حيث أخربش مرارة أيامي على بياض الورق، كانت تأتيني التماعة الرغبة الملحاحة في عينيه اللتين ما تفتآن مسمرتين علي. أحببت انكباب نظراته على حضوري المعطل الغارق في انتظار ما لا يأتي، وغمرني حس بالمعنى في عالم يتراكض قاحلا بلا مبالاة.
باغتني بانتصابه أمام طاولتي، يسألني، بشفتين متبسمتين، ورقة وقلما. ترددت قليلا، وقد فطنت إلى قصده الخفي، ثم أجبته إلى طلبه وكأني أتواطأ معه. حياتي كانت تمتد، في وجهها المشرق، ما بين قلم الرصاص والورقة البيضاء، فكأني أقرضته حياتي...……………………………………….
- من قصص المجموعة “قبض الريح” الحائزة على جائزة الشارقة.