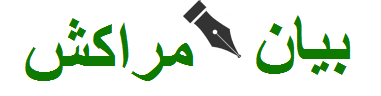تحضير المؤتمر الوطني الحادي عشر للحزب
التطور الديموقراطي ؛ أي أفق؟
بعض عناصر التفكير للاستئناس
بقلم: عبد الرحيم بنصر
عضو المكتب السياسي، عضو هيئة رئاسة اللجنة التحضيرية الوطنية
ما من شك ،أن النضال من أجل الديموقراطية هو ،اليوم، أعلى أشكال التراكم الوطني ،واستقطابه للرأي العام ،والأحزاب والصحافة وقوى المجتمع المدني بحيث يتعذر مقارنته بالتراكم المحقق على جبهة النضال من أجل إقرار العدالة الاجتماعية. غير أنه ، بالنسبة لحزبنا ،وجب التذكير، قبل بسط ما استخلصته من عناصر تفكيري المتواضع حول الموضوع ، أن الديموقراطية لن يكون لها مفعول كبير على حياة الناس إلا إذا أسست على قاعدة العدالة الاجتماعية .أي بصيغة أخرى ،إذا كانت الديموقراطية تهدف ،على المستوى السياسي، إلى توزيع السلطة عن طريق اقتراع يشارك فيه مواطنون متساوون يتمتعون بحرية التفكير والتعبير والتنظيم..، وإلا إذا شكلت ،على المستوى الاقتصادي والاجتماعي، آلية للتوزيع العادل لما أنتج من ثروة وطنية، والاستفادة من الخدمات العمومية الأساسية بصفة منصفة ومتساوية .
انطلاقا من هذا المسعى ،سأحاول تقديم بعض أسباب ما تعرفه الممارسة الديموقراطية ببلادنا من تعثرات أتمنى أن تشكل قيمة مضافة لما قام به الرفاق من اجتهادات جادة ستغني ،دون شك ، تحاليل وبدائل حزبنا .
تخلف الحياة المادية للمجتمع هو أحد المعيقات البنيوية للتقدم الديموقراطي السريع
كثيرا ما يعزى انحدار السياسة والممارسة الديموقراطية لما ارتكبه ،فقط، الفاعلون السياسيون وممثلوهم في المؤسسات المتنوعة من أخطاء.
والحق أن العمل السياسي الحزبي لم يكن مسؤولا ،دائما عن هذا الانحدار، وعن تناقص قاعدة الفاعلين والمهتمين بالشأن العام، وإنما وجدت- إلى جانب الأخطاء تلك-أسباب أخرى لا إرادية، أو ليست بإرادة المؤسسات الحزبية، وهي ،تتعلق ،إجمالا، بالشروط الاجتماعية-الاقتصادية العامة للقوى الاجتماعية التي يتفاعل معها العمل الحزبي ، وما شهدت عليه الشروط تلك من تدني وتدهور.
إن ما آلت إليه السياسات المتبعة من رفع معدلات الفقر والتهميش الاجتماعي افرزت مفارقة : تنمية الثراء الفاحش ، في نطاق بيئات ضيقة من السكان، وتنمية الفقر في البيئات العريضة من المجتمع .وبقدر ما تتغذى ظواهر الفقر والتهميش من سياسات اقتصادية غير إنتاجية، أساسها الاقتصاد الطفيلي والاقتصاد الريعي ، ويتولد منها اضمحلال تدريجي لأعداد القوى العاملة في القطاعات المنتجة ، فهي تتغذى – في الوقت عينه- من سياسات في توزيع الثروة غير عادلة ، سواء بين طبقات المجتمع او بين مناطق البلاد (المدن والبوادي). ولقد تضافرت السياستان معا لتنجبا حالات معممة من الإفقار والتهميش لم تصب قوة العمل المقصية من دوائر الإنتاج فحسب ، بل أصابت ملايين من ذوي الكفاءات العلمية من خريجي الجامعات ومعاهد التكوين العليا لتضمهم، أخيرا إلى جيوش العاطلين.
يتبين إذن، أن النتائج الاجتماعية التي أفضت إليها هذه السياسات مسؤولة، إلى حد بعيد، عما آلت إليه أوضاع السياسة والممارسة الديموقراطية في بلادنا اليوم.
إن مجتمعا يصيب فيه التهميش الاجتماعي فئات واسعة من الشعب، وينخر الفقر والحرمان حياة أكثر السكان، هو مجتمع مقصي، موضوعيا، من دائرة الشأن العام، وبعيد من ميدان السياسة والمشاركة و، بالتالي، لا يملك أن يؤلف جمهورا إيجابيا للعمل السياسي، ولا أن يصنع قاعدة اجتماعية تستطيع السياسة أن تخاطبها. ليس في وسع حالة العطالة والفقر أن تترك للمصاب بها مساحة حياتية أو نفسية للتفاعل مع السياسة والفاعلين السياسيين، فكيف بالانخراط في مؤسسات العمل السياسي ؛ فليس له من الوقت ما يكفي للانشغال بالشؤون العامة، لأنه لا يعرف من الشؤون سوى شؤونه الخاصة، أي أن يوفر لنفسه، ولأهله، لقمة عيش بأي ثمن .
ومما يزيد من حدة المشكلة، ومن اتساع نطاق التباعد بين المجتمع المهمش، المفقّر والسياسة أن القائمين على أمرها يبدون للناس تجارا وانتهازيين لا يبغون غير تحقيق مصالحهم و، بالتالي، تنعدم الثقة بهم وتفقد مؤسساتهم أي معنى يشدهم إليها.
على أن المشكلة في التهميش الاجتماعي والإفقار المعمم أنهما لا يفضيان إلى العزوف عن أي عمل سياسي واجتماعي وإلى اللامبالاة فحسب، وإنما يفضيان إلى إشراك المجتمع في إفساد السياسة والحياة السياسية أيضا. وهذا ما تجسده واحدة من أبرز مظاهر الفساد السياسي، وأشدها خطرا على استقامة أحوال الحياة السياسية ،وهي المال السياسي- الانتخابي وضلوعه في شراء الذمم وتزوير التمثيل.
ما كانت لهذه الظاهرة أن تبرز وتستشري وتتحول إلى قاعدة من قواعد “المنافسة” الانتخابية لولا أن هذا المال وجد البيئة الاجتماعية الخصبة التي يستثمر فيها: فقر الناس وحاجتهم. ومع الأسف أن الفقر والحاجة يدفعان الناس إلى الانخراط في عملية إفساد السياسة من طريق بيع أصواتهم أثناء العمليات الانتخابية.
من الطبيعي ،إذن، أن يجد العمل السياسي والممارسة الديموقراطية نفسهما مصطدمان بظاهرة ضعف المناعة الاجتماعية الشعبية جراء هذه الحال من الإفقار والتهميش الضاربة اطنابها في الجسم الاجتماعي.
إن هذه العوامل جميعها – وغيرها – من جملة العوامل والشروط التي تولد البيئة النابذة للسياسة والعمل السياسي، وتنتج ظاهرة التباعد بين الناس والشأن العام، بين المجتمع والسياسة، وقد تودي(أي الظاهرة) بأوخم العواقب على الاستقرار الاجتماعي .
لذا، على حزبنا الإحاطة بها وبسط شروط تجاوزها عبر البلورة العملية الكاملة للدستور ،نصا وروحا، والترافع المستمر لنهج سياسة تنموية مستقلة تعتمد أساسا على الذات وتسمح بإشباع الحاجيات الأساسية للعيش للغالبية العظمى للناس، وعدم الاقتصار على الاهتمام فقط بالتمثيلية داخل المؤسسات المنتخبة والعودة إلى النضال بجانبهم في الحقول الاجتماعية المتنوعة بتعاون مع القوى الحية الأخرى لتحسين أوضاعهم والرفع من مستوى وعيهم السياسي في اتجاه بروز بيئة عامة تحفز عن الانخراط والمشاركة والمواكبة عبر إطلاق ديناميات جديدة للإصلاح والتغيير .
تعميق نهج القطيعة الديموقراطية نظريا وعمليا
كثيرون هم من يجهلون أن الحزب الشيوعي المغربي( ووريثاه حزب التحرر والاشتراكية وحزب التقدم والاشتراكية) قد سجل منذ تأسيسه سنة 1946 “الاختيار الديموقراطي” كمنهج تراكمي تدرجي لقيادة التغيير من أجل ترسيخ الاستقلال الوطني ومن أجل مباشرة التغييرات الضرورية لنماء البلاد والعباد. ورغم ما تعرض له هذا الحزب من تنكيل ومضايقات ومنع، استمر في حمل هذا المطلب النضالي والتعبير عنه عبر صحافته ووثائقه العديدة وندواته ومؤتمراته السرية والعلنية ،ولم يزغ قط عن هذ الخط إلى يومنا هذا. ولقد شكل التهديد الذي كان يعترض الوحدة الترابية سنة 1972من طرف انفصاليين مساندين من طرف الجزائر وليبيا منعطفا تاريخيا هاما ربط ،خلاله الحزب،النضال من أجل استكمال الوحدة الترابية بضرورة إطلاق مسلسل ديموقراطي وسن إصلاحات اقتصادية واجتماعية لفائدة غالبية المواطنين ولتقوية اللحمة الوطنية و الإجماع الوطني.
إن ما عرفه المغرب من تقدم ملموس ،وبأقل كلفة، هو نتيجة تطورات تخللتها فترات مد وفترات جزر هي وليدة هذه اللحظة التاريخية ووليدة تبصر ملك البلاد والفاعلين السياسيين والتي لازلنا نعيش على وقعها إلى يومنا هذا.
إن الخيار الديموقراطي الذي تبناه الحزب منذ نشأته وفي ظروف بالغة التعقيد ،يتبين مع الزمن، أنه لم يكن أبدا موقفا تاكتيكيا ركن له من باب الاضطرار وإنما اتخذه على أساس إيمان مبكر قوي بالعمل الديموقراطي السلمي التراكمي في سياق إيديولوجي يساري كان ينشد في غالبيته عكس هذا الموقف .
إن الغاية من التذكير بهذا المسار هو التأكيد على أن الديموقراطية ،بالنسبة لحزبنا، كانت ولا زالت هي الطريق الأقوم لتحقيق التنمية الشاملة على قاعدة العدالة الاجتماعية.
غير أن ما قطعته بلادنا من أشواط في مسيرة التقدم والديموقراطية، وما حققه شعبنا من مكتسبات على مستوى الحريات والحقوق ،خصوصا أثناء العقود الثلاثة الأخيرة ما قبل العقد الأخير، أضحت اليوم مهددة بما تتعرض له هذه الحريات ، بين الفينة والأخرى -خصوصا حرية الرأي والتعبير- ، من تراجعات ،وبما يعرفه المجال العمومي من جمود فاقمه ضعف الحضور الحكومي في الحقول التواصلية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والتفاعل مع الفاعلين فيها.
كل هذه العوامل المتداخلة والمتشابكة (اقتصادية واجتماعية وسياسية) المشار إليها أعلاه ،لا تساعد على تأليف جمهور إيجابي للعمل السياسي، ولا أن تصنع قاعدة اجتماعية تستطيع السياسة أن تخاطبها وأن تستدرجها للانخراط في الفعل.
فلا حاجة اليوم إلى وسائل الرصد والتحليل للإقرار أن حياتنا العامة أصيبت بالعياء والضعف الشديدين، وأن ما يملأ النقاش حول الديموقراطية في أيامنا هذه، وما يستأثر بالانتباه والاهتمام هو آليات التمثيل والتعبير واتخاذ القرار والإعلام والدعاية وليس الشروط العامة التي تجعل الديموقراطية ممكنة كتعميم وتجويد التعليم ،تجاوز وضعية الفقر بالنسبة إلى أكثرية الناس، توفير الشغل اللائق، المحو النهائي للأمية، تحسين القدرة الشرائية، التوزيع العادل لما ينتج من خيرات،…لذا أصبح من الضروري والملح على حزبنا العمل من أجل منع خنق الديموقراطية بوسائلها، بعدم الانزلاق إلى حصر تعريفها بالانتخابات. فهذه الأخيرة بالنسبة إلينا عملية إجرائية لا تكتسب طابعا ديموقراطيا من ذاتها. فالديموقراطية بالمعنى الإجرائي شيء والديموقراطية بالمعنى الجوهري شيء آخر.
وتفاديا لأي انتكاسة قد تعود ببلدنا إلى الوراء وتعصف بما حققه شعبنا وقواه الوطنية الديموقراطية ،في إطار التوافق التاريخي، من مكتسبات، نرى أنه لا محيد لنا عن ضرورة الاستمرار في نهج القطيعة الديموقراطية وتعميقها في شموليتها، نظريا وعمليا، بغاية إضفاء المناعة النهائية على مجالنا العام وتحصينه من كل المخاطر أو التقلبات وتوفير المساحات المناسبة للتعبير عن الحقوق ولتحصيلها وتوفير القنوات المناسبة لتصريف الصراعات الاجتماعية تصريفا طبيعيا من دون تعريض النظام السياسي للانغلاق والنظام الاجتماعي للاهتزاز وعدم الاستقرار.
فلا مناص لبلادنا من الاستمرار في تعميق القطيعة الديموقراطية وبأنجح الطرق عمليا ونظريا. فالحاجة ،في السياق الحالي، إلى توضيح معنى الديموقراطية أضحى أمرا ضروريا منهجيا من أجل تبيين ما نصبو إليه كحزب يحمل مشروعا إصلاحيا تغييريا .
انطلاقا مما سبق، إن المهمة الأولى للعمل الصلب والمتماسك في التحول الديموقراطي وبعده، في تطوير الديموقراطية ،تدور حول حقيقة الديموقراطية ،أي حول وضوح الفكرة الديموقراطية ومكوناتها، الذي يقود أي إهمال لأي واحد منها إلى تشويه الديموقراطية ،أو بكل بساطة إلى الخروج منها. ولذلك ينبغي الاهتمام بقوة ،في هذا الطور من الانتقال الديموقراطي، بإعادة توضيح الفكرة الديموقراطية ومتانتها لتمكينها من تجاوز العقبات والاعتراضات والخطوات المتسرعة.
المهمة الثانية هي الإلحاح والنضال من أجل استكمال القطيعة الديموقراطية بتوفير المساحات المناسبة للتعبير عن الحقوق ولتحصيلها وبتوفير القنوات المناسبة لتصريف التناقضات والصراعات الاجتماعية بطريقة سلمية .
المهمة الثالثة تكمن في إيلاء الاهتمام البالغ للظروف الاقتصادية والاجتماعية المعيشية لغالبية المواطنين بغاية مقاومة الشعور بالتخلي عنهم.
وأخيرا ،إن الإقرار بالديموقراطية عبر القانون الأسمى وعبر القوانين التنظيمية لا يضمن تنزيلها على أرض الواقع إلا إذا توفرت إرادة من يدبرون المجتمع ومن بيدهم تنفيذ إراداته. لذا فإن من أهم عناصر بروز الثقة هو السعي الحثيث والدائم للمطابقة بين ما تم إقراره وما تم تفعيله. فالبعد العملي هو الذي من شأنه أن يمنح قيمة فعلية للديموقراطية.